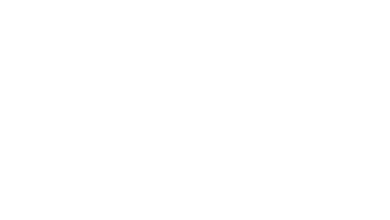هال براندز، جيك سوليفان
والكثير يعتمد على ما إذا كان بإمكان واشنطن معرفة الاستراتيجية التي اختارتها بكين.
إن الصين التي يُظهرها شي جين بينغ تظهر طموح قوة عظمى. قبل بضع سنوات فقط، كان العديد من المراقبين الأمريكيين لا يزالون يأملون في أن تتصالح الصين مع دور داعم في النظام الدولي الليبرالي أو أن تشكل – على الأكثر – تحدياً لنفوذ الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ. وكانت الحكمة التقليدية هي أن الصين ستسعى إلى توسيع دورها الإقليمي – وتقليص دور الولايات المتحدة – لكنها ستذعن لأي طموحات عالمية في المستقبل البعيد. ولكن الآن، فإن الدلائل على أن الصين تستعد للمنافسة على الزعامة العالمية الأميركية واضحة، وهي في كل مكان.
هناك برنامج بناء السفن البحرية، الذي وضع المزيد من السفن في البحر بين عامي 2014 و 2018 من العدد الإجمالي للسفن في القوات البحرية الألمانية والهندية والإسبانية والبريطانية مجتمعة. وهناك محاولة من بكين للسيطرة على صناعات التكنولوجيا الفائقة التى ستحدد التوزيع المستقبلى للقوة الاقتصادية والعسكرية . وهناك حملة للسيطرة على الممرات المائية الحاسمة قبالة سواحل الصين، فضلاً عن خطط تفيد بإنشاء سلسلة من القواعد والمرافق اللوجستية في أماكن أبعد من ذلك. وهناك جهود منهجية لصقل أساليب تحويل النفوذ الاقتصادي إلى قهر اقتصادي في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها.
وليس آخرا، هناك حقيقة أن بلدا كان في السابق يتستر على طموحاته يؤكدها الآن علنا. فقد دخلت الصين في “عهد جديد”، كما أعلن شي في عام 2017، ويتعين عليها أن “تأخذ مركز الصدارة في العالم”. وبعد ذلك بعامين، استخدم شي فكرة “مسيرة طويلة جديدة” لوصف العلاقات الصينية المتدهورة مع واشنطن. وحتى الصدمات الاستراتيجية التي نشأت داخل الصين أصبحت بمثابة عرض للتطلعات الجيوسياسية لبكين: شاهد كيف سعت حكومة شي إلى تحويل أزمة الفيروس التاجي التي تفاقمت بسبب سلطيتها إلى فرصة لإبراز النفوذ الصيني وتسويق نموذج الصين في الخارج.
ومن الصعب تمييز النوايا المحددة للأنظمة الاستبدادية المبهمة. وهناك خطر في الإعلانات النهائية عن النية العدائية لأنها يمكن أن تؤدي إلى القدرية والنبوءات ذاتية الوفاء. ولدينا سوابق مختلفة حول ما إذا كانت العلاقات الأمريكية الصينية المستقرة والبناءة لا تزال ممكنة. ولكن الأمر يتطلب قدراً من الجهل المتعمد ألا نتساءل عما إذا كانت الصين تسعى في الواقع إلى (أو ستسعى حتماً) إلى ترسيخ نفسها كقوة رائدة في العالم، وكيف يمكن أن تحقق هذا الهدف. إن مهندسي استراتيجية الصين الأميركية، أياً كانت غريزياً من حيث استيعابهم أو مواجهتهم، لابد أن يواجهوا هذه القضية بشكل مباشر.
وإذا كان الوضع الحقيقي للقوة العظمى هو الوجهة المرغوبة للصين، فهناك طريقان قد يستغرقهما الأمر في محاولة للوصول إلى هناك.
وإذا كان الوضع الحقيقي للقوة العظمى هو الوجهة المرغوبة للصين، فهناك طريقان قد يستغرقهما الأمر في محاولة للوصول إلى هناك. الأول هو الذي أكد عليه الاستراتيجيون الأميركيون حتى الآن (إلى الحد الذي اعترفوا فيه بطموحات الصين العالمية). ويمر هذا الطريق عبر المنطقة الأصلية للصين، وتحديدا غرب المحيط الهادئ. وهو يركز على بناء الأولوية الإقليمية كمنطلق للقوة العالمية، ويبدو مألوفاً تماماً للطريق الذي قطعته الولايات المتحدة نفسها ذات يوم. الطريق الثاني مختلف جدا لأنه يبدو أنه يتحدى القوانين التاريخية للاستراتيجية والجغرافيا السياسية. ويركز هذا النهج على بناء موقع قوة لا يمكن التهاون معه في غرب المحيط الهادئ أكثر من تركيزه على تطويق نظام التحالف الأمريكي ووجود القوة في تلك المنطقة من خلال تطوير النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي للصين على نطاق عالمي.
إن مسألة أي من هذه الطرق ينبغي أن تتخذها الصين هي مسألة ملحة بالنسبة للاستراتيجيين في بكين، الذين سيواجهون قرارات صعبة بشأن ما يجب الاستثمار فيه – وما الذي يحارب لتجنبه – في السنوات المقبلة. ومسألة الطريق الذي ستُتخذه الصين لها تداعيات عميقة على الاستراتيجيين الأميركيين ـ وفي نهاية المطاف على بقية العالم.
أول حاملة طائرات صينية الصنع تنطلق لإجراء تجارب بحرية في داليان، الصين، في 13 مايو 2018. استثمرت بكين بكثافة في برنامجها لبناء السفن البحرية، الذي وضع المزيد من السفن في البحر بين عامي 2014 و2018 من العدد الإجمالي للسفن في القوات البحرية الألمانية والهندية والإسبانية والبريطانية مجتمعة. صور غيتي
وترى الحكمة التقليدية الناشئة أن الصين سوف تحاول ترسيخ النفوذ العالمي من خلال فرض الهيمنة الإقليمية أولاً. وهذا لا يعني احتلال الدول المجاورة مادياً (باستثناء تايوان)، كما فعل الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة. ولكن هذا يعني أن بكين لابد وأن تجعل من نفسها اللاعب المهيمن في غرب المحيط الهادئ، إلى سلسلة الجزر الأولى (التي تمتد من اليابان إلى تايوان إلى الفلبين) وما بعدها؛ يجب أن تحصل على حق النقض الفعال على الأمن والخيارات الاقتصادية لجيرانها؛ يجب أن تمزق التحالفات الأمريكية في المنطقة وتدفع القوات العسكرية الأمريكية إلى أبعد وأبعد من شواطئ الصين. وإذا لم تتمكن الصين من القيام بذلك، فلن يكون لديها أبداً قاعدة إقليمية آمنة يمكن من خلالها توليد القوة على الصعيد العالمي. وسيواجه تحديات أمنية مستمرة على امتداد محيطه البحري الهش؛ سيكون عليها أن تركز طاقاتها وأصولها العسكرية على الدفاع بدلا من الهجوم. وطالما احتفظت واشنطن بموقع عسكري قوي على طول سلسلة الجزر الأولى، فإن القوى الإقليمية – من فيتنام إلى تايوان إلى اليابان – ستحاول مقاومة صعود الصين بدلاً من استيعابها. وببساطة، لا يمكن للصين أن تكون قوة عالمية حقيقية إذا ظلت محاطة بحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الأمنيين، والقواعد العسكرية، وغيرها من المواقع الأمامية لقوة عظمى معادية.
وأحد الأسباب التي تجعل هذا السيناريو يبدو معقولاً بالنسبة للأميركيين هو أنه يشبه إلى حد كبير طريقهم إلى الأولوية. منذ الأيام الأولى للجمهورية، أدرك المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن لا يمكن أن تتصور لعب دور رئيسي في الشؤون العالمية إلى أن تطور درجة من القهر الاستراتيجي داخل أمريكا الشمالية ونصف الكرة الغربي الأكبر. كان هذا هو المنطق الاستراتيجي الذي ربط العديد من مكونات حملة دامت عقودًا لطرد المنافسين الأوروبيين من نصف الكرة الأرضية، من مبدأ مونرو في عشرينيات القرن التاسع عشر من خلال كسر القوة الإسبانية في منطقة البحر الكاريبي خلال حرب عام 1898. وكانت الفكرة نفسها تدعم الجهود التي بذلت على مدى قرن من الزمان – وبعضها غامض أخلاقياً بل إشكالياً للغاية – لمنع الأوروبيين من إعادة موطئ قدم في المنطقة، من نتيجة روزفلت في عام 1904 مروراً بالحرب شبه السرية التي تشنها إدارة ريغان ضد نيكاراغوا ساندينستا، التي كانت متحالفة مع كوبا والاتحاد السوفياتي، في الثمانينيات.
فقد أوضحت لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أثناء الحرب الباردة أن القوة العالمية لأميركا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموقعها الإقليمي المهيمن. وذكرت اللجنة” ان قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على توازن قوى مقبول على الساحة العالمية بتكلفة يمكن السيطرة عليها تعتمد على الامن المتأصل لحدودها البرية ” . وإذا كان على أميركا أن “تدافع ضد التهديدات الأمنية بالقرب من حدودها”، فإنها “ستتحمل عبئا دفاعيا متزايدا بشكل دائم … ونتيجة لذلك يجب أن تقلل من الالتزامات الهامة في أماكن أخرى من العالم”.
ومن المؤكد أن هناك دلائل على أن الصين قد ابتلت هذا المنطق نفسه لأن العديد من سياساتها تبدو محسوبة على أساس الأولوية الإقليمية. وقد استثمرت بكين بكثافة في الدفاعات الجوية المتقدمة والغواصات الهادئة والصواريخ المضادة للسفن وغيرها من قدرات الحرمان المضادة للوصول/المنطقة اللازمة لإبعاد السفن والطائرات الأميركية عن شواطئها حتى تتمكن من الحصول على يد أكثر حرية في التعامل مع جيرانها. وقد ركزت بكين على تحويل بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي إلى بحيرات صينية – للعديد من الأسباب الكامنة نفسها، كما يتصور المرء، وهي أن الولايات المتحدة كانت مصممة على طرد منافسيها من منطقة البحر الكاريبي.
وأحد الأسباب التي تجعل هذا السيناريو يبدو معقولاً بالنسبة للأميركيين هو أنه يشبه إلى حد كبير طريقهم إلى الأولوية.
وعلى نحو مماثل، استخدمت الصين مزيجاً من الإغراءات والإكراه والتلاعب السياسي في محاولة لإضعاف علاقات أميركا مع شركائها العسكريين وحلفائها في المعاهدة. وقد روج المسؤولون الصينيون لفكرة “آسيا للآسيا” – وهي إشارة غير مبطنة إلى فكرة أن المنطقة يجب أن تسوي شؤونها دون تدخل الولايات المتحدة. وعندما كشف شي ومستشاروه عن مفهوم “النموذج الجديد للعلاقات بين الدول الكبرى”، كان الاقتراح الأساسي هو أن الولايات المتحدة والصين قد تتفقان إذا بقيت كل دولة على جانبها من المحيط الهادئ.
وأخيراً، لم يخف جيش التحرير الشعبي حقيقة أنه يبني قدرات إسقاط القوة العسكرية اللازمة لإخضاع تايوان، وهو تطور من شأنه أن ينقلب على توازن القوى الإقليمي بين عشية وضحاها، ويُشكك في بقية التزامات أميركا في غرب المحيط الهادئ. يعتقد بعض المحللين أن الحرب بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان ستكون – إما الآن أو في غضون بضع سنوات – أساساً بمثابة رمية. إن كل هذه السياسات تُلَكِد بانعدام الأمن الأساسي مع قرب أميركا الاستراتيجي من الصين. وبالطبع، فإن كل هذه ال يتسق مع الهدف الأضيق المتمثل في الهيمنة الإقليمية. ولكنها أيضاً تتفق مع ما قد يتوقعه المرء لو كانت بكين تحاول محاكاة مسار أميركا إلى القوة العالمية.
ولكن هناك أسباباً تدعو إلى التساؤل عما إذا كان هذا هو المسار الذي سوف تسلكه الصين حقاً، إذا كانت تسعى في الواقع إلى الحصول على مركز عالمي للقوى العظمى. في الشؤون الدولية، هناك دائماً خطر كبير في تصوير المرآة – في افتراض أن الخصم يرى العالم بنفس الطريقة التي نرى بها، أو سيحاول تكرار تجربتنا الخاصة. وهذا هو الحال هنا بشكل خاص لأنه يجب أن يكون واضحاً لبكين الآن أنه سيكون من الصعب على الصين إخضاع محيطها الإقليمي أكثر مما كانت عليه بالنسبة للولايات المتحدة.
لم تواجه الولايات المتحدة أبداً اليابان – وهي قوة إقليمية كبيرة متحالفة مع قوة أكبر – في نصف الكرة الأرضية الخاص بها، ويعني تجاوز سلسلة الجزر الأولى تجاوز اليابان. ولم يكن عليها أبداً أن تتعامل مع عدد المنافسين – الهند وفيتنام وإندونيسيا وغيرها الكثير – التي تواجه الصين على طول أطرافها الإقليمية والبحرية. فهي لم تواجه أبداً قوة عظمى تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها التحدي الأكبر الذي تواجهه، بدلاً من النظر إليها ببساطة على أنها انزعاج أو منافس أقل ينبغي استرضاءه لضمان دعمها ضد التهديدات الأكثر إلحاحاً. إن محاولة الهيمنة الإقليمية تخاطر بتركيز المنافسة الاستراتيجية على تحدٍ تتفوق فيه الولايات المتحدة عادةً – الفوز في المنافسات العسكرية الراقية ذات التقنية العالية – وببساطة دفع جيران الصين إلى مزيد من الأسلحة في واشنطن. وحتى الآن، كانت جهود بكين في الإغواء والإكراه ناجحة جزئياً في تغيير التوجه الجيوسياسي للفلبين وتايلاند، ولكنها أتت بنتائج عكسية في التعامل مع أستراليا واليابان. وباختصار، ليس من الواضح أن بكين تستطيع أن تسلك بنجاح مساراً إقليمياً نحو القوة العالمية – الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك طريق ثانٍ للقيادة العالمية الصينية.
زائر يستكشف مركز المعارض في مؤتمر التنمية الاقتصادية الرقمية في الصين – والذي يضم الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد من الجيل الخامس – في يانغتشو في 28 نيسان/أبريل. ويعتقد البعض ان بكين تستخدم رأسها فى الانتعاش من الفيروس التاجى للمطالبة بحصة سوقية اضافية فى الصناعات الرئيسية حيث ينخفض المنافسون مؤقتا . صور غيتي
ماذا لو أن الصين، بدلاً من التركيز على الهيمنة الإقليمية قبل التحول إلى النظر في الهيمنة العالمية، التفت إلى الأمور على العكس؟ وهذا الطريق الثاني من شأنه أن يقود الصين إلى غربها أكثر من شرقها، في خدمة بناء نظام أمني واقتصادي جديد بقيادة الصين عبر الكتلة البرية الأوراسية والمحيط الهندي، مع إقامة مركزية صينية في المؤسسات العالمية. وفي هذا النهج، سوف تقبل الصين على مضض بأنها لا تستطيع أن تُحَل الولايات المتحدة من آسيا أو تدفع البحرية الأميركية إلى ما وراء سلسلة الجزر الأولى في غرب المحيط الهادئ، على الأقل في المستقبل المنظور. وبدلاً من ذلك، فإن هذا من شأنه أن يركز بشكل متزايد على تشكيل القواعد الاقتصادية ومعايير التكنولوجيا والمؤسسات السياسية في العالم لصالحها وفي صورته.
وتتمثل الفرضيات الرئيسية لهذا النهج البديل في أن القوة الاقتصادية والتكنولوجية هي الأهم أساسا من القوة العسكرية التقليدية في إقامة القيادة العالمية، وأن وجود منطقة نفوذ مادية في شرق آسيا ليس شرطا مسبقا ضروريا للحفاظ على هذه القيادة. ومن هذا المنطق، يمكن للصين ببساطة أن تستمر في إدارة التوازن العسكري في غرب المحيط الهادئ – مع مراعاة محيطها المباشر، وخاصة مطالبها الإقليمية من خلال مبدأها المناهض للوصول إلى المناطق/إنكارها، وتحويل ارتباط القوى لصالحها ببطء ، مع السعي إلى الهيمنة العالمية من خلال هذه الأشكال الأخرى من القوة.
وبوسع الصين ببساطة أن تستمر في إدارة التوازن العسكري في غرب المحيط الهادئ مع السعي إلى الهيمنة العالمية من خلال أشكال القوة الأخرى هذه.
وهنا، ستنظر بكين في اختلاف مختلف من تشبيه الولايات المتحدة. كانت القيادة الأمريكية للنظام الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، ثم توطدت بعد نهاية الحرب الباردة، ترتكز على ثلاثة عوامل حاسمة على الأقل. أولاً، القدرة على تحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي. ثانياً، الحفاظ على ميزة الابتكار على بقية العالم. وثالثا، القدرة على تشكيل المؤسسات الدولية الرئيسية ووضع القواعد الرئيسية للسلوك العالمي. وفي هذا الطريق الثاني، سوف تسعى الصين إلى تكرار هذه العوامل.
وسيبدأ ذلك بالطموح المتزايد لمبادرة طريق الحزام في جميع أنحاء أوراسيا وأفريقيا. إن بناء وتمويل البنية التحتية المادية يضع الصين في مركز شبكة من الروابط التجارية والاقتصادية التي تمتد عبر قارات متعددة. كما أن العنصر الرقمي في هذا الجهد، وهو طريق الحرير الرقمي، يعزز هدف الصين المعلن من مؤتمر الحزب لعام 2017 المتمثل في التحول إلى “قوة عظمى إلكترونية”، من خلال نشر التقنيات التأسيسية الصينية، وقيادة وضع المعايير في الهيئات الدولية، وتأمين المزايا التجارية طويلة الأجل للشركات الصينية. (هناك مؤشرات على أن الصين تستخدم حتى السبق في التعافي من الفيروس التاجي لدفع هذه الأجندة من خلال المطالبة بحصة إضافية في السوق في الصناعات الرئيسية حيث يتم وضع المنافسين منخفضة مؤقتا). ومن خلال الجمع بين السياسة الاقتصادية الخارجية العدوانية والاستثمارات المحلية الضخمة الموجهة من الدولة في مجال الابتكار، يمكن للصين أن تبرز كلاعب رائد في التكنولوجيات التأسيسية من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمومية إلى التكنولوجيا الحيوية.
ومع بناء الصين للقوة الاقتصادية من خلال هذه الجهود، فإنها سوف تزيد من قدرتها على تحويل تلك القوة إلى نفوذ جيوسياسي. فقد حدد إيفان فايغنباوم من مؤسسة كارنيغي أنواعاً متعددة من النفوذ الذي يمكن أن تستخدمه الصين “لقفل تفضيلاتها السياسية والاقتصادية”، بدءاً من الكامن والسلبي إلى النشط والقسري. وتقيّم أن بكين ستواصل صقل استراتيجية “المزيج والتطابق” التي تنشر المجموعة الكاملة من هذه الأدوات في عمليات الغبار مع مجموعة متنوعة من البلدان، من كوريا الجنوبية إلى منغوليا إلى النرويج. وفي نهاية المطاف، قد تتكيف الصين سلماً أكثر انتظاماً للتصعيد من أجل تحقيق النتائج المفضلة.
وكما بنت الولايات المتحدة المؤسسات الرئيسية في صورة ما بعد الحرب السياسية، فإن هذا الطريق الثاني من شأنه أن يقود الصين نحو إعادة تشكيل المعايير السياسية المركزية للنظام الدولي. وقد وثّق عدد من الدراسات الصحافة التي تُستخدم في المحاكم الكاملة في بكين عبر منظومة الأمم المتحدة لحماية الأسهم الصينية الضيقة (إنكار وضع تايوان في الأمم المتحدة، وعرقلة الانتقادات الموجهة إلى الصين) وتعزيز التسلسل الهرمي للقيم التي تتفوق فيها السيادة الوطنية على حقوق الإنسان. وأصبحت عبارة “القوة الحادة” شائعة الآن commonplace لوصف الجهود التدخلية التي تبذلها الصين للتأثير على الخطاب السياسي في البلدان الديمقراطية بما في ذلك أستراليا والمجر وزامبيا. كما أن بكين تعزز بسرعة ثقلها الدبلوماسي، حيث تمر على الولايات المتحدة في عدد المناصب الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وتوسع نفوذها باستمرار في التمويل المتعدد الأطراف، والمناخ العالمي والمؤسسات التجارية، وغيرها من الهيئات الرئيسية لوضع القواعد. يلاحظ تارون شهبرا من معهد بروكينغز باقتدار أن نهج بكين في التعامل مع الإيديولوجية قد يكون مرناً،ولكن تأثيره التراكمي هو توسيع مساحة الاستبداد وتقييد مساحة الشفافية والمساءلة الديمقراطية.
قد يكون نهج بكين في التعامل مع الإيديولوجية مرناً، ولكن تأثيره التراكمي هو توسيع مساحة الاستبداد.
كان المحرك الرئيسي الآخر للقيادة الأميركية في فترة ما بعد الحرب الباردة وما بعدها، بطبيعة الحال، هو نظام التحالف القوي والمرنة. هذا هو أقل المتاحة كأصل لبكين. ومع ذلك، بدأ القادة الصينيون في إنشاء شبكة محتملة من القواعد العسكرية خارج شواطئ الصين، بدءاً من جيبوتي. وللتعويض عن عجز التحالف، شرعت الصين في وضع استراتيجية لإضعاف هيكل التحالف الغربي وتقسيمه، وزراعة بلدان أوروبا الشرقية وأضعفت الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.
وتأتي كل هذه الجهود في وقت تراجعت فيه الولايات المتحدة عن دورها التقليدي كضامن للنظام. وهذا قد يكون العنصر الأكثر أهمية على الإطلاق.
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على الاستثمارات العسكرية والأمنية التقليدية، التي تمنح الولايات المتحدة القدرة على الحفاظ على دورها كقوة مادية مقيمة في آسيا. ولكنه أظهر اهتماماً أقل كثيراً بمواجهة التحدي العالمي الذي تشكله الصين ـ على الأقل بطريقة متماسكة. وقد كانت استجابة الولايات المتحدة للفيروس التاجي رمزية للأسف حتى الآن، حيث جمعت بين الجهود الخرقاء لتذكير العالم بأن الفيروس نشأ في الصين باستجابة محلية غير كفؤة وغياب نسبي للقيادة الدولية المبدئية التي كانت تقليدياً أفضل إعلان لأولوية الولايات المتحدة. وفي الماضي، كان من الممكن توقع أن ترى الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية الرامية إلى تنسيق الحوافز الاقتصادية وتدابير الصحة العامة العالمية؛ ومن المؤكد أن المرء لم يكن ليتوقع أن تفشل الحكومة الاتحادية فشلاً سيئاً في صياغة استجابة وطنية ونشر معلومات دقيقة. وعلى ضوء كل الحديث عن منافسة القوى العظمى، فإن السيناريو المعقول هو أن الصين تملأ تدريجياً الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، مع استيعاب بقية العالم لعالم من القوة الصينية المتنامية، في غياب أي بديل قابل للتطبيق.
ويبدو من غير المرجح بطبيعة الحال أن تقبل الصين البارزة عالمياً الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة على محيطها البحري. ولكن قد يكون الوصول إلى القيادة العالمية مجرد وسيلة لتطوّر موقف الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ – لجعلها غير قابلة للاستمرار من خلال تراكم النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي وليس من خلال الضغط السياسي العسكري أو المواجهة.
مما لا شك أن هذا المسار له أيضاً مشاكله. وقد تكون الصين أقل قدرة على توفير المنافع العامة العالمية من الولايات المتحدة، سواء لأنها أقل قوة ولأن نظامها السياسي الاستبدادي يجعل من الصعب ممارسة القيادة المستنيرة نسبياً والمحصلة الإيجابية التي ميزت أولوية الولايات المتحدة. أزمة الفيروس التاجي يقطع كلا الاتجاهين في هذا الصدد. ومن المؤكد أن رد الولايات المتحدة المتراخية قد ضاعف المخاوف العالمية بشأن الكفاءة والموثوقية الأمريكية، إلا أنها أظهرت أيضاً كيف يمكن للصين أن تتصرف بشكل غير مسؤول ومهين – من التستر على الفاشية الأولية بطريقة شجعت انتشارها العالمي إلى تلفيق قصة سخيفة حول كيفية نشأ الفيروس في الولايات المتحدة لبيع الاختبارات المعيبة إلى البلدان التي هي في حاجة ماسة إليها. لقد تعبت الحكومات في البلدان الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا بالفعل من ممارسات بكين التجارية المفترسة، والجهود الرامية إلى السيطرة على الصناعات الرئيسية، والرغبة في قمع حرية التعبير في العالم الديمقراطي من خلال إسكات الانتقادات الموجهة إلى ممارساتها في مجال حقوق الإنسان. ومن خلال إظهار الجوانب الأكثر قتامة للنموذج الصيني، فإن أزمة الفيروس التاجي قد تشجع أيضاً على مقاومة أكبر لطموحات بكين العالمية.
إن التوترات المحيطة بصعود الصين لا تنتج ببساطة عن المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المتضاربة. كما أنها تعكس انعدام ثقة أعمق وأكثر تأصلا.
وأخيراً، هناك حاجز إيديولوجي أمام الزعامة الصينية. إن التوترات المحيطة بصعود الصين لا تنتج ببساطة عن المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المتضاربة. كما أنها تعكس انعدام ثقة أعمق وأكثر تأصلاً غالباً ما يصيب العلاقات بين الحكومات الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية القوية. إن هذا الهوة بين القيم السياسية لبكين وقيم الديمقراطيات في العالم تعني أن العديد من البلدان في أوروبا وخارجها تبدأ من موقف عدم الارتياح إزاء الدور المتنامي للصين في الشؤون العالمية. ولكن لا شيء من هذا يعني أن بكين لن تحاول مواصلة اتباع هذا المسار – الذي يبدو أنه يزداد اتساعاً ودعوة في الوقت الذي تُنكم فيه الولايات المتحدة من علاقاتها وتستنزف هيبتها.
الناس الذين يرتدون زي الجيش الأحمر يؤدون عروضهم في افتتاح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في ييانغ في 18 أكتوبر 2017. وفي الاجتماع، أعلن الرئيس شي جين بينغ أن بلاده دخلت “عهداً جديداً” وعليها أن “تأخذ مركز الصدارة في العالم”. صور غيتي
أي تحليل “الطريقين” يجب أن تواجه السؤال الواضح: ماذا لو كان كلاهما – أو لا؟ ومن الناحية العملية، يبدو أن استراتيجية الصين تجمع حالياً بين عناصر النهجين. وحتى الآن، كانت بكين تحشد الوسائل وتسعى إلى النفوذ الجيوسياسي لمواجهة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ، فضلاً عن وضع نفسها في موقف يتصدى لتحدي عالمي أوسع نطاقاً. ومن الممكن تماماً أيضاً ألا تقطع بكين المسار بنجاح في نهاية المطاف، إذا تعثر اقتصادها أو نظامها السياسي أو استجاب منافسونها بفعالية.
ومع ذلك، وفي كلتا الحالتين، فإن تحديد خيارات بكين لا يزال ممارسة مفيدة لثلاثة أسباب.
فهو أولاً يساعد في صياغة الخيارات الاستراتيجية والمفاضلات التي ستواجهها الصين في السنوات المقبلة. وكثيراً ما تبدو موارد الصين هائلة، ولكنها مع ذلك محدودة: فالدولار الذي ينفق على صاروخ قاتل حامل أو غواصة هجومية هادئة لا يمكن إنفاقه على مشروع للبنية الأساسية في باكستان أو أوروبا. كما أن اهتمام كبار القادة الصينيين ورأس المال السياسي محدودان. فالبلد الصاعد الذي يواجه منافسين هائلين، ولا يزال يواجه صعوبات داخلية هائلة، لا يستطيع إلا أن يواجه هذا العدد الكبير من التحديات الجغرافية – السياسية والجيو اقتصادية دون الإفراط في اغـراض موارده أو تخفيف أثر جهوده. ومن المنطقي إذن أن تحديد الطريق إلى الهيمنة الواعدة سيكون الشغل الشاغل المستمر للمخططين الصينيين – وليس أقل من المسؤولين الأمريكيين الذين يجب أن يحددوا رد واشنطن.
ثانياً، تساعد هذه العملية على توضيح التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة. وقد جادل بعض كبار محللي الدفاع الأميركيين بأنه إذا لم تفز بكين بالمنافسة العسكرية على طول محيطها البحري، فإنها لا تستطيع منافسة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. ويُحَلِق هذا التحليل أهمية كبيرة على الولايات المتحدة في القيام بالاستثمارات العسكرية ومتابعة الابتكارات التكنولوجية والعملياتية اللازمة لتعزيز توازن القوى في مضيق تايوان وغيره من النقاط الساخنة الإقليمية التي بدأت بالفعل في التلميح.
وقد تخسر الولايات المتحدة المنافسة مع الصين حتى لو تمكنت من الحفاظ على موقع عسكري قوي في غرب المحيط الهادئ.
وهذه الاستثمارات والابتكارات حاسمة حقا. ومع ذلك، يثير تحليلنا إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة المنافسة مع الصين حتى لو تمكنت من الحفاظ على موقع عسكري قوي في غرب المحيط الهادئ. وهو يذكرنا بأن أدوات المنافسة الأكثر ليونة – من توفير مصادر بديلة لتكنولوجيا الجيل الخامس والاستثمار في البنية التحتية إلى إظهار القيادة الكفؤة في معالجة المشاكل العالمية – ستكون بنفس القدر من الأهمية كأدوات أكثر صعوبة في التعامل مع التحدي الصيني. وهو يشير إلى أنه سيكون من المهم بنفس القدر الدفاع عن التحالفات والشراكات الأمريكية من الانحلال الداخلي – الذي يعجل به شراء النفوذ الصيني والعمليات الإعلامية – وذلك لحماية هذه التحالفات والشراكات من الضغوط العسكرية الخارجية. كما أنه يقدم تحذيراً بأن الاستثمار بكثافة في الجيش الأمريكي مع اختصار الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، وتفريغ شبكة العلاقات العالمية الأميركية، وإضعاف المؤسسات الدولية أو التراجع عنها، قد يكون خطيراً بقدر ما هو الفشل في تعزيز العمود الفقري العسكري للقوة المتشددة لوجود واشنطن في الخارج.
وأخيراً، فإن التفكير في طريقين للهيمنة في الصين يوضح كيف ستكون المنافسة بين الولايات المتحدة والصين مماثلة للحرب الباردة ومختلفة عنها. ثم، كما هو الحال الآن، كان هناك مسرح عسكري مركزي واجه فيه المتنافسون بعضهم البعض بشكل مباشر: أوروبا الوسطى. وخلال الحرب الباردة، أدت الصعوبات والأخطار الناجمة عن محاولة طرد الولايات المتحدة من ذلك المسرح إلى قيام السوفييت بمناورة جانبية. لقد بحثت موسكو عن الميزة في العالم النامي من خلال استخدام المساعدات الاقتصادية والتخريب والتضامن الإيديولوجي مع الحركات الثورية؛ وقد سعت إلى تفريغ علاقات التحالف الأمريكي في أوروبا وخارجها من خلال الضغط العسكري الضمني والتدخل السياسي.
وستكون المنافسة بين الولايات المتحدة والصين مماثلة للحرب الباردة ومختلفة عنها.
ومع ذلك فإن الاتحاد السوفييتي لم يكن أبداً منافساً خطيراً على الزعامة الاقتصادية العالمية؛ بل كان منافساً خطيراً على الزعامة الاقتصادية العالمية. لم تكن لديها القدرة، أو التطور، على تشكيل المعايير والمؤسسات العالمية بالطريقة التي قد تتمكن بكين من القيام بها. كانت القوة السوفيتية في نهاية المطاف ذات أساس ضيق للغاية ، مما حد من الخيارات الاستراتيجية التي تمتلكها موسكو. وفي حين أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي شهدا الصراع بعبارات المانوية – الخير مقابل الشر، النصر مقابل الهزيمة، البقاء مقابل الانهيار – هناك اليوم فارق بسيط أكبر في علاقة تجمع بين المنافسة الحادة المتزايدة وترابط لا يزال كبيراً.
ولا تزال الولايات المتحدة لديها القدرة على الاحتفاظ بأكثر من نفسها في تلك المنافسة، طالما أنها لا تستمر على المسار الحالي للتخريب الذاتي. ولكن حقيقة أن الصين لديها مساران معقولان للسبق تعني أن المنافسة سوف تكون أكثر تعقيداً، وربما أكثر تحدياً، مما كانت عليه أثناء آخر منافسة بين القوى العظمى في أميركا
مجلة فورين بوليسي